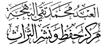الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين واللّعن على أعدائهم أجمعين.
رزقنا الله التوفيق للعمل بكلّ ما نعلم. فإنْ عمِلْنا بما نعلم، ولم نجعله تحت أقدامنا، ولم نغضّ عنه أبصارنا [فسيستقيم أمرنا]. أمّا إذا غطّينا أعيننا ووضعنا اليد على العين فنحلف أنّنا لا نرى النهار. وهذا صدق، ليس كذباً! فطالما غطّى المرء عينه بيده فإنّه لا يری النهار ولا اللّيل، ولا يرى أي شيء آخر. وكذا الحال بالنسبة لعدم العمل بالمعلومات.
«مَن عَمِل بِمَا عَلِم أورَثه الله عِلْم ما لا يَعلَم»[1] من عمل بمعلوماته، جعل الله مجهولاته معلومات، بدليل أنّ نفس هذه المعلومات التي يمتلكها حالياً ما كانت لديه أيّام الصبا والطفولة. الله علّمه نفس هذه المعلومات بالتدريج. فحتماً من لم يجعل معلوماته تحت أقدامه [سيوفقه الله و] قل [له]: اذهب وكن مرتاحاً، كن مطمئناً. وقتها ستغدو عالِماً بما تحتاجه![2]. بل في الرواية ما هو أعلى من ذلك: «مَن عَمِلَ بِمَا عَلِم كُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَم»[3] يقال له: «قف [أي حسبك وكفيت] يا أيّها العامل بالمعلومات! لا تفكّر بشيء آخر، إنّ بقيّة الأمور عليهم[4]؛ فنفس أُولئك الّذين أعلموكم هذا المقدار، سيعلمونكم الزيادة عن هذا المقدار أيضاً. أنت لا تفكّر بعدها، أي لا تغتمّ له!».
إلى الآن هل هناك من يقول: «إنّني لم أحضر أيّ مجلس وعظ لواعظ لحدّ الآن، لم أسمع من أيّ ناصح شيئا!». إنّه يكذب! أجل، هذا الكلام كذب. فلقد سمعتَ جيّداً، هل عملْتَ [بما سمعت] أم لم تعمل؟ لو عملت كنت متنوّراً؛ لماذا؟ لأنّهم بنفس عملكم [بمعلوماتكم] سيعلّمونكم مجهولاتكم، ليكن بالكم مرتاحاً [اطمئنّوا].
أمّا إذا لم تعمل [بالنصائح]، وتريد فقط أن تسمع وتسمع وتسمع، [إذن] متى ستعمل؟ بعد أن يُرفع الستار [و يُكشف الغطاء]، في ذاك الوقت تريد أن تعمل؟!
إذن فلنعلم بأنّنا إذا جعلنا النصائح [السابقة] تحت أقدامنا، فإنّ النّصيحة الحالية والموعظة الحالية سنضعهما تحت أقدامنا أيضاً. وإنْ وضعناها تحت أقدامنا، فلنطمئنّ أنّه لن يكون هناك خبر[5]؛ لماذا؟ لأنّهم لا يعلّمون لعباً [و عبثاً]، لا يعلمون لأجل أن تكتب وتضع جانباً. كما لو أخذنا وصفة الطبيب ووضعناها في جيبنا الجانبي. ولم نكترث بعدها ـ ليكون في جيبنا الجانبي ـ كم بذلنا الجهد وأعطينا المال حتّى حصلنا على الوصفة![6] أليس من الواجب أن تعمل بها؟
لو عملنا[7] لتنوّرنا، لو كنّا قد عملنا بالنصائح والمواعظ، لكنّا متنورين الآن. تلك الأسئلة وتلك الدروس[8] لا تتنافى مع عملنا أبداً؛ كأنّنا نريد أن نجد دواء هذا المرض بتصفّح الكتاب!
إذن يجب أن نعلم أنّنا بأنفسنا أساتذة أنفسنا. فتعالوا ننظر إلى معلوماتنا أن لا تكون قد بقيت تحت الأقدام. فمحال أن تكون هناك عبوديّة ويكون هناك ترك للمعصية ـ ومع هذا الفرض ـ يكون الإنسان لا حيلة له ولا يدري ما يفعل وما يترك؛ هذا محال!
« وَ مَا خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُون »[9]، لأنّ العبوديّة هي ترك المعصية في الاعتقاد والعمل. فإذا قال أحدهم: «لا أعلم، أنا متوقّف [أي متحيّر]»، [ذلك] لأنّه كثيراً ما عمل من نحو هذه الأمور[10] وضع المعلومات تحت الأقدام و[مع هذا] يقول: «لا أعلم!! هل من أحد يتصدّق عليّ؟ يدلّني؟». يا هذا! كلّ هذه الإرشادات الّتي كانت ... حسبتها[11]؟!
إذن حتماً: كونوا دعاةً إلى الله بغير ألسنتكم، ادعوا إلى الله بأعمالكم، لا باللّسان الّذي ربّما تعمل معه أو لا تعمل[12]. نفس الشخص الّذي يقول [النصيحة][13] غير معلوم أنّه يعمل [بها] أو لا يعمل، فضلاً عن الّذي يسمعها. انظروا إلى أعمال من تعتقدون بهم، واتّخذوا من أعمالهم أنموذجاً.
[لا تقتصر على النظر الى من تعتقد بهم ولكن اقتدِ بعملهم، واتّخذه منهاجاً] هذه هي الدعوى. جالسوا [عاشروا] من إذا رأيتموه تذكرون الله وطاعته، لا من يفكّرون بالمعاصي ويمنعون الإنسان من ذكر الله.
إذن اعلموا أنّ المشكلة من أنفسنا، وإلاّ لو عملنا لكان أمرنا صلاحاً. بل إنّ الإنسان العاقل، الإنسان المتأمّل يفهم مساوئ الأعمال؛ ينظر اليوم، والغد، وبعد الغد، كيف يُغلبون ويُهلكون. فيصير معلوماً لديه أن العمل السيّء يؤدّي إلى الهلاك.
يستطيع المرء أن يتعلّم الأدب من عديمي الأدب أيضاً، فضلاً عن المؤدّبين. إذن فالنّاس على قسمين: «المتيقّن» و«غير المتيقّن». المتيقّن يسير حتّى النهاية نحو اليقين بشرط أن لا يضع قدمه خارج بساط اليقينيّات، وأن لا يَعدّ اليقينيّات غير يقينيّة، وأن يمشي مع اليقين، ويتوقّف عند غير اليقين حتّى يتبدّل إلى يقين، ويحتاط حتّى يصير يقيناً.
إذن ـ وبشكلٍ قهري ـ الإشكالات كثيرة في أعمالنا، ومن جملة ذلك أنّه مع أنّنا متيقّنون، فإنّنا لا نملك اليقين [لا نتيقن]. عندنا يقين، لكنّا جعلنا يقيننا كالعدم كأنّه لا يوجد عندنا يقين. وإلّا فلو أنّنا تعاملنا مع اليقين أنّه يقين، ومع عدم اليقين أنّه لا يقين، لكنّا مرتاحين؛ حتّى لو تيقنّا أننا سنستشهد، لأجل أنّه، ما هي الشهادة؟[14] [هل] الشهادة هزيمة؟ كلا، سيّد الشهداء (عليهم السلام) لم يُهزم ، بل انتصر، ولا زال غالباً لدى أهل البصيرة! وسيأتي الزمن الّذي سيتيقّن النّاس أغلبهم، أي طريق خطأٍ وأي طريق سوء سلكنا[15]!؟ ما أسوأ الطريق الّذي سلكناه، فقد تعايشوا[16] مع الشيوعيّة مدّة نيفٍ وسبعين عاماً، بلّغوا ضد الدّين، ارتكبوا الفظائع، وقتلوا كلّ من زعموا أنّه يعارضهم، ثمّ فهموا، لا، يا هذا نهايتها هي بئر الهلاك، نهايتها هي العدم.
هذه السبُعِيّة والوحشيّة سببها أنّهم نسوا الله منذ اليوم الأوّل. فكونوا مطمئنين من أنّ هؤلاء الّذين هم[17] موجودون الآن ومع كلّ ما يمتلكون من شخصية فإنّهم سيندمون في النّهاية، لكن في يوم قد لا يفيدهم النّدم شيئاً.
في نهاية الأمر محال أن يكون لهذه البيوت الورقيّة بقاء ودوام وثبات، مع كلّ هذه الرياح والرياح المعاكسة. محال أن يكون لها بقاء!
هذا البقاء الّذي تشاهدونه لهم ما هو؟ السباع المفترسة يمتلكون هذا البقاء أيضاً؛ ينشغلون ليلهم ونهارهم في التفكير في كيفية إهلاك الطرف [الآخر]، بل لا شغل لهم بدين أحد، إلّا بالمقدار الّذي يكون مقدمة لرئاسة أنفسهم وتوسعة ملكهم [بهذا القدر] تكون مقدمية للفظ الدّين[18]. ولو استطاعوا أن يجعلوا الدّين بالشكل الّذي يوافق مقاصدهم السياسيّة لصاروا جميعهم متديّنين، ولتوافدوا جميعهم إلى الكنائس، ولأقبلوا جميعهم على العبادة. نعم، يصبحون متعبّدين كثيراً كثيراً، ولجعلوا فلاناً من المتعبّدين معهم.
المقصود: اطمئنوا وكونوا متيقّنين، فإنّ «سلمان» كان قد رأى المستقبل ـ لأنه كان ذا يقين ـ ولذا قال: لا تكونوا فرحين بهذا الظفر، بل إذا أدركتم سيّد شباب أهل الجَنّة الّذي ترونه الآن، فكونوا أشدّ فرحاً! هذه القضية ستقع في السّنوات اللاحقة، فإذا رأيتموه ستكونون أشدّ فرحاً، وهذا ما يقال: إنّ سيد الشهداء (عليهم السلام) ذكّر زهيراً. (و هو أن زهيراً) عند ما كان راجعاً من المعركة مسروراً وكانت الغنائم كثيرة فقال [سلمان]: إذا أدركتم سيد شباب أهل الجنّة «لكنتم أشدّ فرحاً»[19].
المقصود: أنّ الناس على وجه الأرض قسمان: «المتيقّن، وغير المتيقّن». فالمتيقّن مرفوع الرأس، والله يعلم أيّ مقام رفيع له. فهل بقي ذاك المقام[20] لسلمان أم [أن مقامه] ارتقى؟
وأيضا «المقداد» و«أبو ذر» و«عمّار» وأمثالهم، الّذين أتوا يوماً بعد يوم باستمرار.[21]
[علينا أن] لا نفكر في القول والمقال، [بل علينا أن] نفكّر بالعمل. فإذا فكّرنا بالعمل بالمعلومات[22]، إذن لنطمئنّ أنّنا لن نفشل، وسنتنوّر أكثر يوماً بعد يوم.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[1] روضة المتقين، ج ٢، ص ٣٢٢. و في البحار، ج ٤٠، ص ١٢٨: عن النبي صلّى الله عليه و آله: «من عمل بما يعلم ورّثه الله علم ما لم يعلم».
[2] أي إن لم تضع معلوماتك تحت أقدامك، فالأمور الّتي لم تكن تترقّب إنجازها، فتُيسّر لك بسهولة.
[3] عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام): «من عمل بما علم كُفِيَ ما لم يعلم». ثواب الأعمال، ص ١٣٣.
[4] أي على مدبّرات الأمور.
[5] أي أنّنا لن نحصل على شيء.
[6] أي كأننا أخذنا وصفة الطبيب لنجعلها في جيبنا و لا نتعالج بها.
[7] أي عملنا بما تلقّينا من نصائح و مواعظ.
[8] أي الحضور في مجالس الدرس.
[9] سورة الذّاريات، الآية ٥٦.
[10] أي أنه كان يجعل معلوماته تحت قدميه.
[11] أي هل أعطيتها أهمية.
[12] يعني سماحته (البالغ مناه) أن تدعوا الى الله بأعمالكم الّتي أحرزتم كونها نصيحة عملية للآخرين لا بألسنتكم التّي تقول نصيحة لم تقدموا أنفسكم على القيام بها.
[13] أي الشّخص الّذي يعظ النّاس بلسانه و هو نفسه لا يعمل بما يقول!
[14] أي أبناء الدنيا لعلّهم ينظرون الى الشّهادة نظر الخسران و الفناء و الواقع خلاف ذلك بل هي ربح و بقاء و سعادة.
[15] أي يقول الناس: «أي طريق سلوك سلكنا!» أي نحن معاشر النّاس.
[16] أي الحكومة الشيوعية في روسيا المسماة بولشيويك.
[17] أي جميع الكفّار الّذين يمتلكون الثروة و الملك.
[18] أي لهم عمل بلفظ الدين و حسب و ليس بنفس الدين و أحكامه، فالدين لعق على ألسنتهم.
[19] وحدث جماعة من فزارة و من بجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين البجلي حين أقبلنا من مكة، فكنا نساير الحسين عليه السلام فلم يكن شئ أبغض إلينا من أن ننازله في منزل ، فإذا سار الحسين عليه السلام و نزل منزلاً لم نجد بداً من أن ننازله، فنزل الحسين في جانب و نزلنا في جانب، فبينا نحن جلوس نتغذى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتّى سلّم ثم دخل، فقال: يا زهير بن القين إنّ أبا عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه. فطرح كلّ إنسان منّا ما في يده حتّى كأنّ على رؤوسنا الطير، فقالت له امرأته: سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه، لو أتيته فسمعت من كلامه، ثم انصرفت. فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه و ثقله و رحله و متاعه فقوض و حمل إلى الحسين عليه السلام، ثم قال لامرأته: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإنّي لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، ثم قال لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعني، و إلّا فهو آخر العهد، إنّي سأحدّثكم حديثاً: إنّا غزونا البحر، ففتح الله علينا و أصبنا غنائم، فقال لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه: أفرحتم بما فتح الله عليكم، و أصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم، فقال: إذا أدركتم شباب آل محمد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم ممّا أصبتم اليوم من الغنائم. فأمّا أنا فأستودعكم الله. قالوا: ثمّ و الله ما زال في القوم مع الحسين عليه السلام حتّى قتل رحمة الله عليه». الإرشاد، ج ٢، ص ٧٣.
[20] أي تلك المرتبة العالية الّتي كان عليها.
[21] يقصد سماحته: أي الّذين جاؤوا من بعدهم من أصحاب أهل البيت R و العلماء أصحاب المقامات السامية الّذين كانوا على نهجهم.
[22] أي ما يرتبط بالدين من أحكام ومسائل نعلمها.