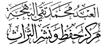لا شكّ أنّ الأوقات الّتي كان يقضيها «محمّد تقي» مع أساتذته في حوزة فومن العلميّة، وهم خرّيجو الحوزة العلميّة في النّجف الأشرف، كان يتخلّلها الكلام عن ذلك الجوّ العلميّ المقدّس، ومحاضر الدّروس الرّائعة الّتي تتّصف بها الحوزات العلميّة في العراق، خاصّة تلك الّتي ترفل بأَردية الشّرف والقداسة بجوار باب مدينةِ العِلْم أمير المؤمنين (عليه السّلام) وسيّد الشّهداء (عليه السّلام)، ممّا كان يسبّب زيادة حرارة الوجد والشّوق في قلب هذا التّلميذ العصاميّ الّذي كان شوقه للإمام الحسين (عليه السّلام) قد اختلط بلحمه ودمه منذ طفولته، وكان أُستاذه الشّيخ أحمد السّعيدي يشير على والده الميرزا محمود الكربلائي بأن يبعث ولده «محمّد تقي» إلى النّجف ليكمل دراسته وينهل من علوم أهل البيت (عليهم السّلام)، وكان يصرّ على ذلك لما كان يرى من نوره وقدسه، ولم يكن قد بلغ الحلم في ذلك الوقت، وقد اقتنع الميرزا بكلامه لما يرى من نبوغ عقل ولده وصفو سريرته، وكان يحاول استباق الزّمن وطيّ المسافات لكي يرد تلك الدّيار النيّرة، ويحضر تلك الدّروس البهيجة حتّى إذا ما حانت الفرصة أسرع «محمّد تقي» ليضع قدمه على طريق الهجرة الّتي حان وقتها وكان ذلك في جمادى الآخرة سَنَة ١٣٤٨ هـ . ق، حيث أودعه والده الرّؤوف الّذي لمس شوق ولده المتأجّج لتلك الدّيار، بكفالة أحد أصدقائه من ذوي المكنة الّذي كان عازماً على زيارة الأئمّة الطّاهرين (عليهم السّلام) كي يوصله إلى كربلاء المقدّسة، وهكذا كان، حيث سارت القافلة يحدوها أمل اللّقاء مع مقام سيّد الشّهداء (عليه السّلام)، وباب الحوائج أبي الفضل العبّاس (عليه السّلام)، ولكنّها خلّفت وراءها منزلاً حزيناً وأباً عطوفاً يقف على باب الدّار يرمق غلامه البارّ بنظرات الوداع، وفي العين دمعة، وفي القلب غصّة، وعلى اللّسان يجري الدّعاء بحفظ الفتى الطّاهر «محمّد تقي».
فقلب المحبّ قلق على حبيبه، فعلى الرغم من أنّ الوالد يعلم أنّ أخاه «الميرزا عَليّاً الأكبر» سيكون خير كفيل لمهجة قلبه ـ حيث إنّ «محمّد تقي» سيكون بضيافة عمّه ـ وإنّه سيرعاه بأشفار عيونه، ويحنو عليه ويهتمّ به، إلاّ أنّ هذا الأمر لم يهدّئ من روعه، ولم يسكّن من سريرته، فكلّ شيء في الدّار يذكّره بحبيبه، فأرجاء المنزل كان يلفّها الحزن، وكلّ زاوية فيه تحاكي مشهداً من مشاهد الحبيب، هنا كان يصلّي وهنا كان يتلو آيات من الذّكر الحكيم ...